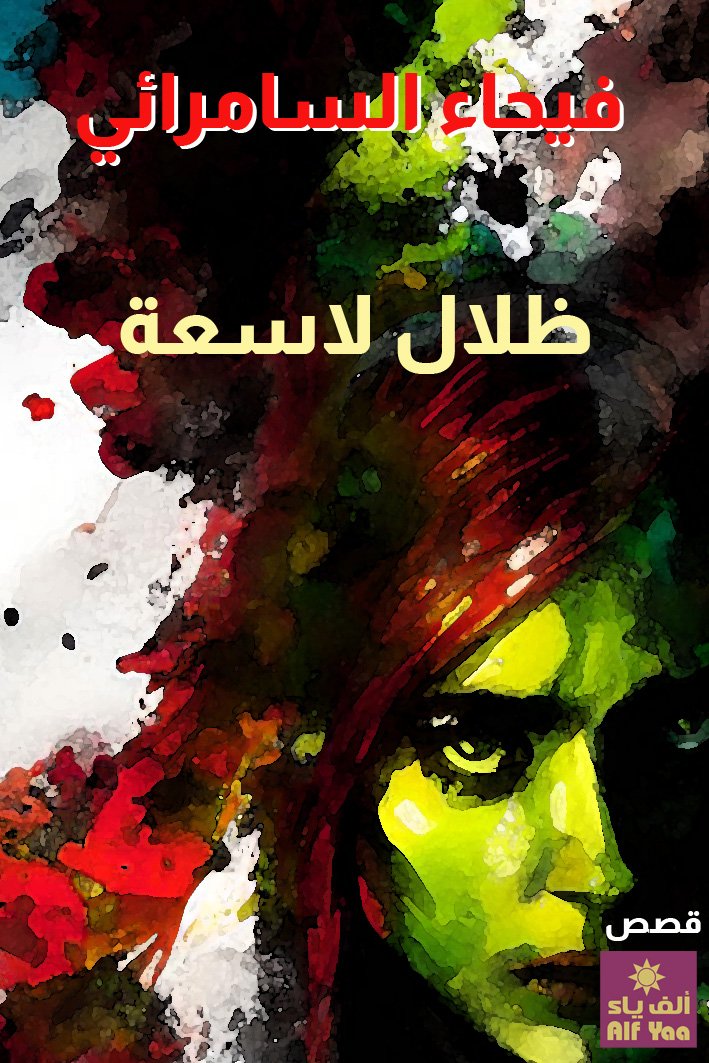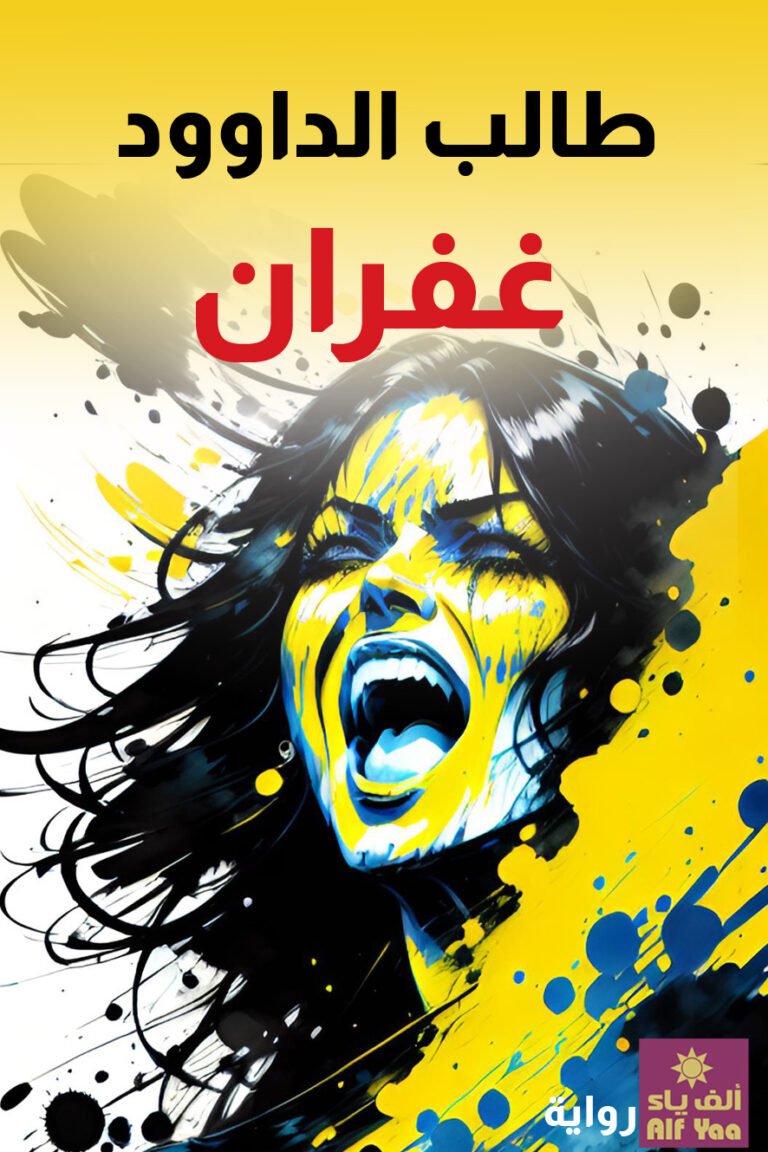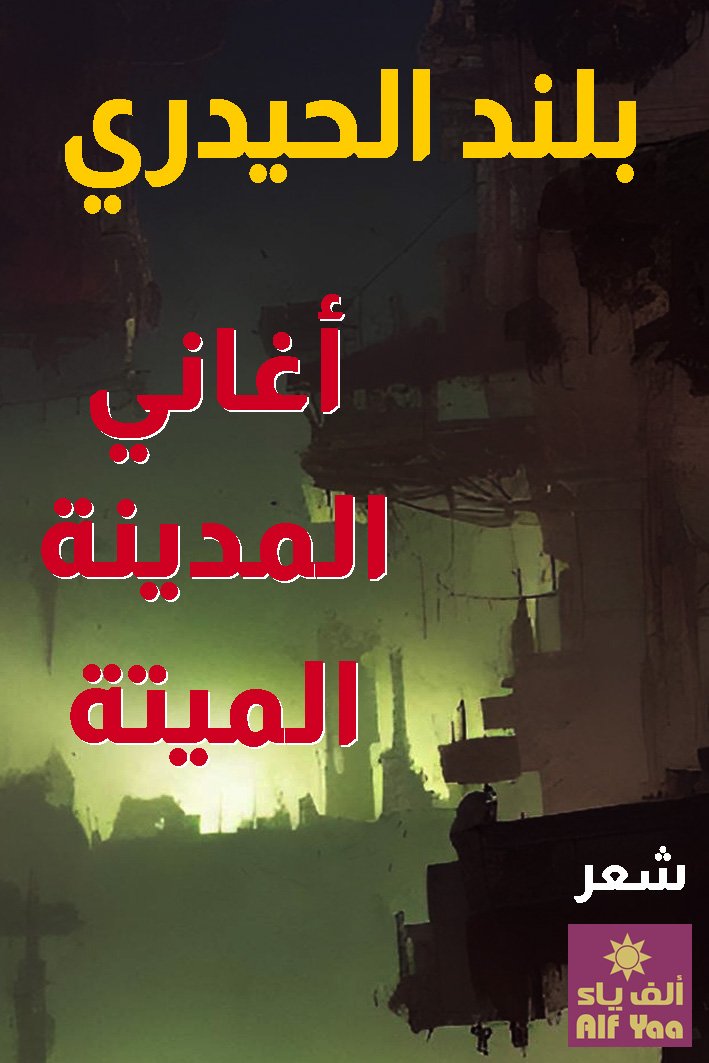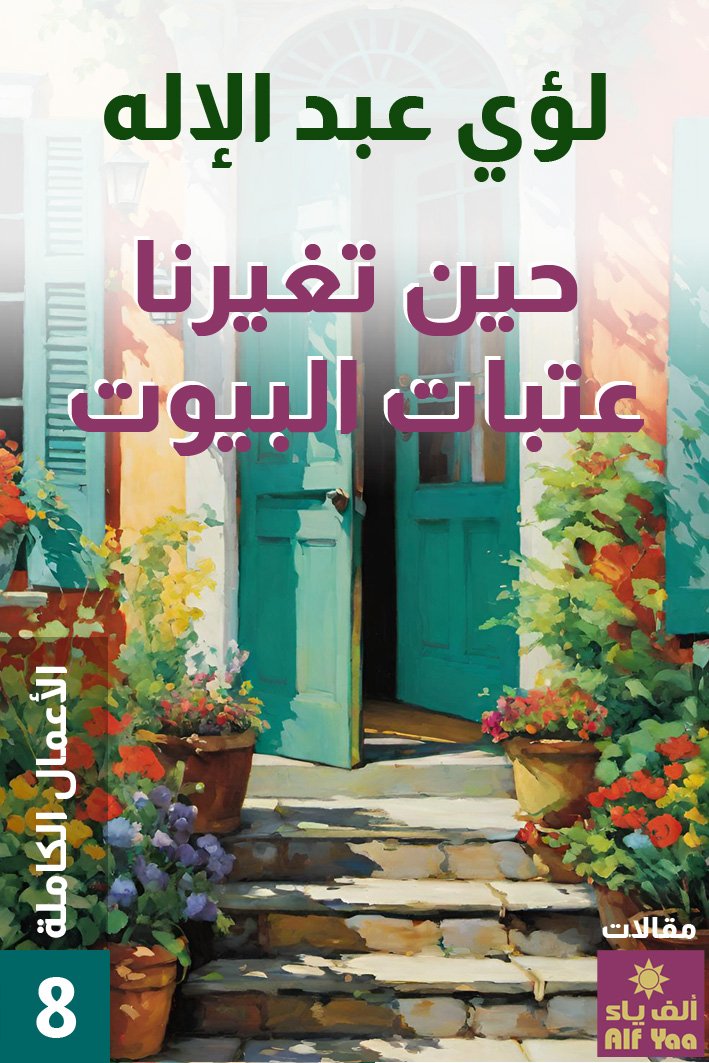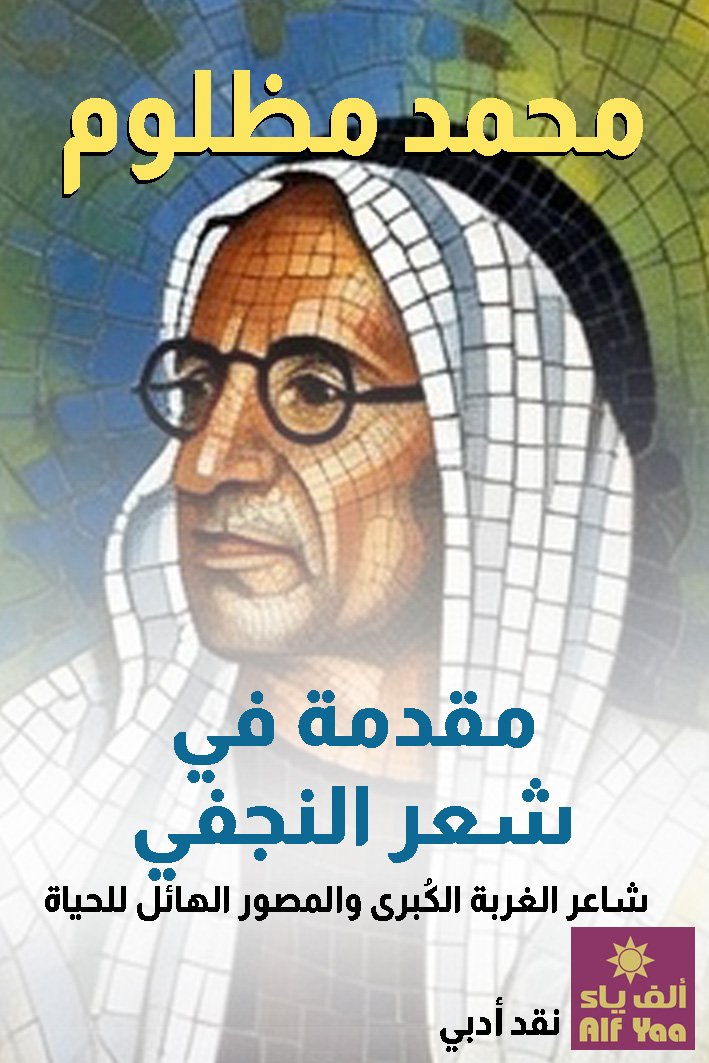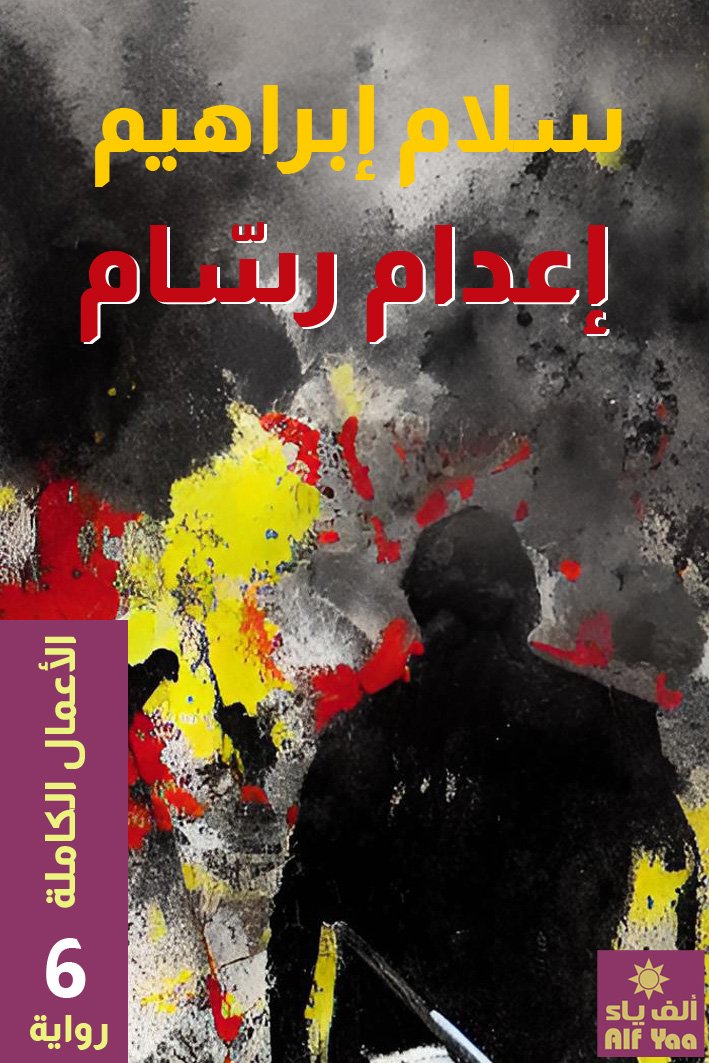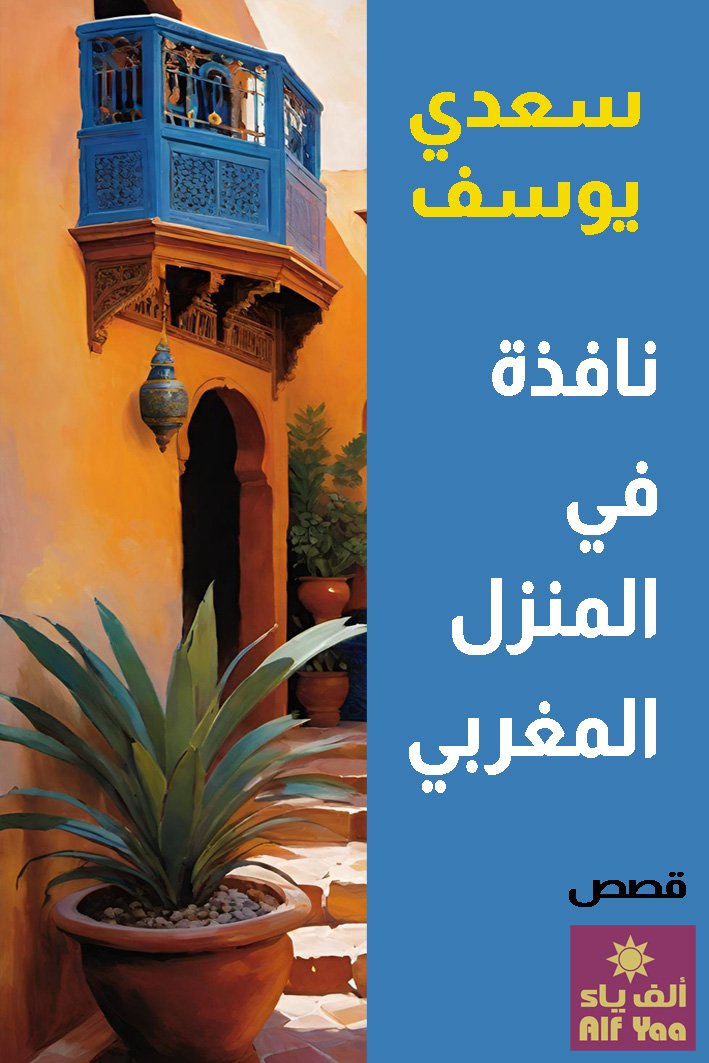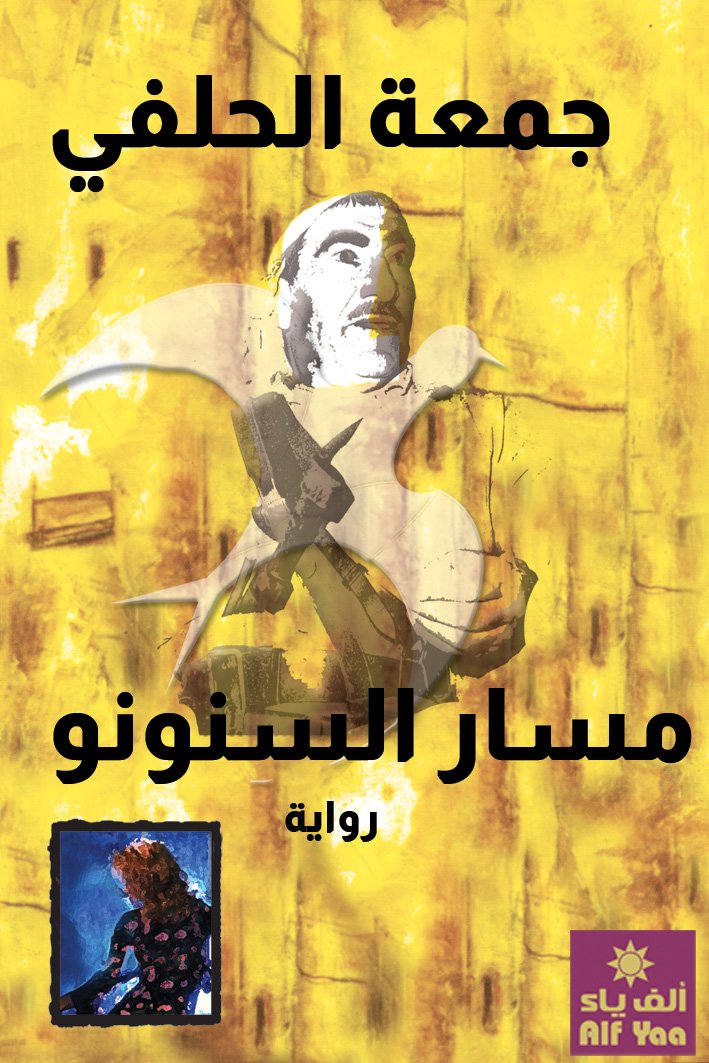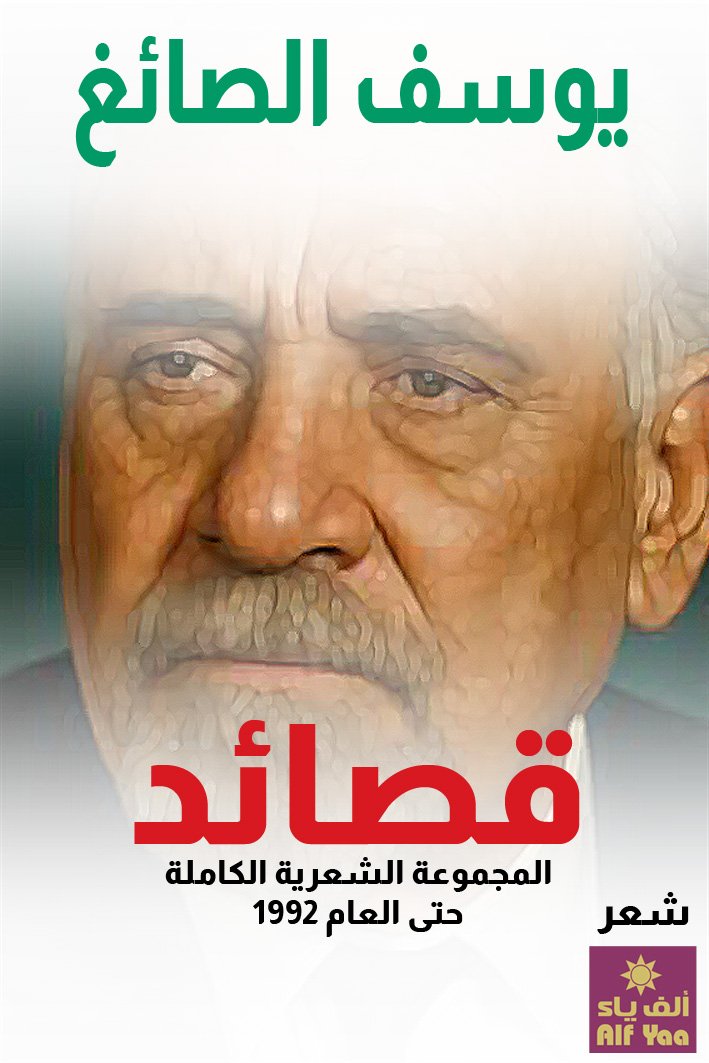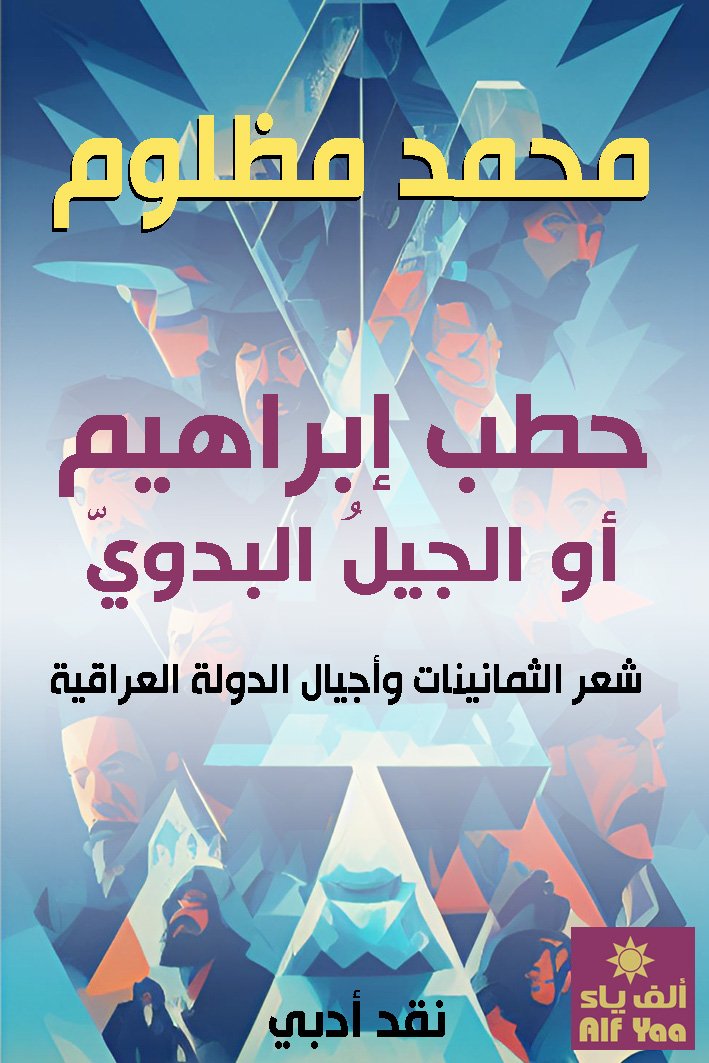


بطاقة الكتاب:
الكاتب: محمد مظلوم
الكتاب: حطب إبراهيم
النوع: نقدر أدبي
القياس: 15سم * 22.5سم
الصفحات: 478 صفحة
يُعد الحديث عن تجربة جيل الثمانينات الشعري في العراق غوصاً في مرحلة بالغة التعقيد والتشابك ضمن التاريخ الأدبي العراقي، وقد تبدو متأثرة بشدة بتركة جيل السبعينات وما رافقها من تحولات سياسية قاسية واجتماعية وثقافية استمرت آثارها، وإنما أيضا بتركة جيل الستينيات ومجموعة كركوك بشكل خاص، حيث عمل الجيل الجديد على إثارة غبارٍ مشابهٍ لعاصفة الستينيين
ورث الثمانينيون إرثاً ثقيلاً من تناحر أيديولوجي وأنماط شعرية متناقضة خلفها شعراء من الجيلين السابقين ، اللذان عاشا تحت وطأة هلع سياسي وارتباك اجتماعي، نتج عنه هجرة عدد كبير من شعرائه وانقسام نتاجه بين شعر منفي في الخارج وشعر داخل العراق، بالإضافة إلى صدامات داخلية شرسة بين تياراته.
واجه شعراء الثمانينات الأساسيون (مثل محمد مظلوم، نصيف الناصري، باسم المرعبي، صلاح حسن، ناصر مؤنس، سعد جاسم، وسام هاشم، وآخرين) هذه التراجيديا عند ظهورهم. مثّل عقدهم مرحلة مراجعة نقدية للسبعينات واتخذ بعضهم اجتهادات وموفقا من مجمل الشعر العربي الحديث بانحياز وانتقائية ، وعملوا على ولادة مشروع شعري جديد تأسس على قصيدة النثر، سعى لبناء هوية مستقلة ببنى واجتهادات خاصة.
تَحولُ بؤرة الصراع من الانتماءات الحزبية إلى النزاع بين جدية المشروع الشعري التجريبي الطليعي من جهة، ومحاولات النظام المستمرة لتهميشه واستبداله بـ”ثقافة طليعية” وتشجيع الشعر الداعم لسياسته من جهة أخرى.
تعرض مجموعة من هذا الجيل للتجاهل والقمع الثقافي المنظم داخل العراق؛ حيث منعت المؤسسات الرسمية نشر نتاجهم طوال سنوات، مما أجبر الغالبية العظمى منهم على نشر دواوينهم الأولى خارج البلاد (خاصة في بيروت)، في سابقة متجددة تاريخيا عاشها الكثير من شعراء الأجيال الأقدم.
برز في الثمانينات تياران رئيسيان: الأول تيار طليعي تجريبي سعى لتأسيس قصيدة نثر حديثة معقدة اجتماعياً ونفسياً وسياسياً، وقدم رؤية مغايرة عن الحرب، بعيداً تماماً عن المؤسسة الرسمية ومرتكزاً على التجريب والجدل الطليعي. مثله شعراء مثل محمد مظلوم ونصيف الناصري وباسم المرعبي وصلاح حسن وناصر مؤنس بتجربته الفريدة، وسعد جاسم وعبد الحميد الصائح. والتيار الثاني تيار القصيدة اليومية واللقطة الشعرية، الذي اتسم بالرومانسية والوضوح النسبي، وحظي بدعم بعض النقاد الذين رأوا فيه بديلاً “مريحاً” عن تعقيد التيار الأول، وضم شعراء مثل عدنان الصائغ وعبد الرزاق الربيعي وأمل الجبوري.
عانى الجيل من إشكاليات نقدية حادة: عدم اكتراث نقدي، ومعايير انتقائية، وتقويم باهت. ووقع الباحثون في فخ التناقضات؛ فالبعض اختزل التجربة في كونها “إعلام شعري لثقافة الحرب” وتابع للسلطة
رغم هذه الضغوط الهائلة، داخل العراق وخارجه، ورث جيل الثمانينات إشكالات الثقافة العراقية كافة وأنتج تنوعاً وتعددية في التيارات الشعرية، حافظ في سنين لاحقا على جذوة التجريب والطليعيةـ ثم انكفأت الأغلبيةـ وأصبحت أسماء أغلبهم نوعا من بقايا صدى خافت.
يحاول محمد مظلوم، وهو أحد أبرز وجوه هذا الجيل، في كتاب “حطب إبراهيم” توصيف حركة جيل شعراء الثمانينات في العراق واستحضار تجربتهمٍ الشعريَّة التي تشكَّلت تحت وطأة ظروفٍ استثنائيَّة. “فمع بزوغ ملامح هذا الجيل الأدبي، اندلعت الحرب العراقيَّة الإيرانيَّة الطويلة، التي خلَّفت ركاماً من المعاناة والحصار والعنف، دفنَ تحتَهُ الملامحُ الأولى لهذه التجربة وطَمَسَ صيرورتها”.
يَذُكر المؤلف في مقدمته الكتاب، أن هذا العمل محاولةٍ لـ”إنقاذ” ذلك الماضي المدفون، ليس لإحيائه، بل لإنصافه وكشفِ حقيقته في زمنٍ طَغَتْ فيه الأكاذيبُ المصنَّعة وتبديلُ الأقنعة. إنَّه وعدٌ قديمٌ لتأريخ “مرحلة” أُجِّلَ توثيقُها عمداً، وروايةٌ أخرى تنقضُ روايةَ الزيفِ الضخمة التي تَشكَّلَتْ في الثقافة العراقيَّة. وهو شهادةٌ شخصيَّة محضةٌ عن جماعةٍ من الشعراء، وليست روايةً جماعيَّةً متوافَقاً عليها، قابلةٌ للنقضِ والقبولِ، لكنَّها تنتمي بقوةٍ إلى سياق تلك “الفترة” المُلتبسة.
ويقول محمد مظلوم أن هذا الكتابُ “قطيعةٌ” مع الماضي ومع “الجماعة”، لا بمعنى الإنكار، بل بمعنى “التطهُّر” الأرسطيِّ منه. كتابةٌ كهذه تحملُ روحَ التطهير، وتستفزُّ شهوداً آخرين لحملِ رواياتهم. الهدف ليس التجريحَ أو الفضائحيَّة، بل تفكيكُ بنى النصوص والمواقف الثقافيَّة (المساومة، المقاومة، المستسلمة، أو حتى “الخائنة” لضميرها الثقافيِّ) بكشفِ التلبيس والتحرُّرِ من ثقافةِ الادعاء. الموضوعيَّة المطلقة هنا مستحيلة؛ فالمؤلفُ يعترفُ بانحيازه في مراجعةِ خياراتٍ ثقافيَّةٍ ووجوديَّةٍ عاشَها.
يصرّح محمد مظلوم بأن إنجازُ هذا المشروعِ تأخَّرَ سنواتٍ بسبب الصراعاتِ الأدبيَّةِ حول تجاربَ سابقةٍ (جيل الستينيَّات)، وخوفٍ من تحوُّلهِ إلى “شهادةٍ جماعيَّةٍ” مشوَّهةٍ أو أداةِ تصفيةِ حسابات. كما أحاطَتْ بهِ ضغوطٌ وتنويعاتٌ “مختلفة النوايا”، بينَ منْ يسعى لـ”خطفِ” الفكرةِ أو دعواتٍ لدفنِ فكرةِ “الأجيال” الأدبيَّةِ نفسها. لكنَّ استحقاقَ هذهِ التجربةِ الفريدة، التي تُوثِّقُ ليس فقط عقداً شعرياً بل تراكمَ صراعاتِ النخبِ وأثرَها على علاقةِ المجتمعِ بالدولةِ ومؤسساتِها الثقافيَّة، جعلَ الإصدارَ ضرورةً تاريخيَّةً وموضوعيَّةً. هو محاولةٌ لوضعِ فكرةِ “الأجيالِ” الأدبيَّةِ أمامَ محكِّ النقدِ الجذريِّ، بعد أنْ غدتْ مسلَّمةً لم يُناقشْ أساسُها.
طالب الداوود